الامبراطور
مشرف المميز


نقاط : 61
 |  موضوع: المدرسة والاسرة: النواة الصلبة في تماسك بنى المنظومة الاجتماعية موضوع: المدرسة والاسرة: النواة الصلبة في تماسك بنى المنظومة الاجتماعية  الأحد ديسمبر 05, 2010 5:35 am الأحد ديسمبر 05, 2010 5:35 am | |
| المدرسة والاسرة: النواة الصلبة في تماسك بنى المنظومة الاجتماعية
يعتبر إشكال فك العزلة عن المدرسة، وإخراجها من بوثقة السكونية وسلبية الحياد، بتكسير سياجات التهميش والإقصاء المضروبة حولها، من أهم الأوراش الاستراتيجية التي ينكب عليها فكر التجديد، وتطولها مواقف التغيير في منظومة الإصلاح الشمولية التي يشهدها قطاع التربية والتكوين بمغربنا الراهن.إن إصلاح المؤسسة المدرسية، يظل شأنا مبثورا بل ومشلولا إذا تم دون ربطها بمؤسسة الأسرة بشكل خاص، وبمحيطها السوسيوثقافي وخصوصياته المميزة له بشكل عام. فلا يمكن اعتبار المدرسة بأي حال من الأحوال، نسقا تربويا معزولا عنهما، ذلك أن جدلية التأثر والتأثير بينهما واقع ملزم بطبيعته الحتمية. كما أن منطق الاستمرارية والتكامل في وظائفهما الإنسانية والتربوية والاجتماعية، تظل دينامية قائمة الوجود لا جدال فيها.بذلك يصبح مدخل تجسير العلاقات ولحم الفجوات بين المدرسة والأسرة، تعاقد اجتماعي حاسم يفرض ذاته باستمرار نظرا لطبيعة التداخل والاندماج بين هذين القطبين المركزيين وظيفيا، ولطبيعة مكانتهما المرموقة في بنى المنظومة الاجتماعية إنسانيا، إضافة إلى التحامهما حول وحدة الرهان ووحدة الغايات المشتركة : كلاهما معا من أجل الارتقاء بالمنظومة التنموية البشرية في بلادنا.كما أن وحدة الوظائف والأدوار، دعوة أكيدة وملحة إلى ضرورة انكفاء مساحة القطيعة والتنافر بينهما، وانحسار الهوة االفاصلة بين المؤسستين، والتي بصمت علاقتهما لزمن غير هين... لتحتل مكانها قيم: التعاون، والتآزر، والتطوع، وروح المبادرة..إن تواجد كل من المؤسسة المدرسية والأسرية جنبا إلى جنب في جوهر الرسالة التربوية، لدليل حي وقاطع على عمق الروابط بينهما في التأثيث لملامح المشهد المجتمعي، عن طريق البناء المشترك لشخصية الإنسان المغربي.فلا جدل في كون الأسرة تتربع مكانة المؤسسة الاجتماعية الأم بامتياز، باحتلالها موقع النواة الصلب في مهام التنشئة الاجتماعية لأبنائها. فهي الوسط الطبيعي والتلقائي المعول عليه لتربية الطفل، وتوفير حاجاته، وإشباع رغباته، واحتضانه بملإ الدفء في عاطفة الانتماء في المراحل الأولى الحاسمة في حياته، والمسؤولة على تحديد السمات الكبرى لشخصيته الأساسية، وميولاته ونزوعاته السيكونفسية، وعلى تطبيع سلوكاته مع خصوصيات واقعه الاجتماعي.بذلك يقترن النظام الأسري بمهام تحديد طبيعة الروابط المعنوية والمادية للطفل مع ذاته، ومع العالم الخارجي الصغير حوله، وبتوفير الفضاء الملائم لاستدخال الأفكار الإيجابية، واستنبات المبادئ والقيم المثلى لديه، والتي تعكس ماهية المجتمع وطبيعة فكره الروحي والأخلاقي.وهي توازنات توجد على علاقة كبيرة مع درجة التماسك الأسري، ومتانة الروابط الحميمية، وقوة التواصل بين الأطراف المكونة لها، ومدى إيجابية التفاعل العلائقي والعاطفي بينهم.بذلك تتموضع الأسرة في موقع الكيان الأساس، الذي يشكل بداية الانطلاق في التنشئة الاجتماعية للكائن الإنساني عندما يلبس ثوب الحياة، وهي تسري في جسه دماء الوجود الاجتماعي.إلا أن استمراريتها تلك، ومشروعية رسالتها النبيلة لا تكتمل ولا تنضج إلا بوجود المدرسة، كمؤسسة تربوية نظامية تضمن الامتداد الحقيقي لها. فهي بمثابة الواجهة الأخرى والكبرى للمؤسسات الاجتماعية المنوطة بمهام السهر على تربية وتكوين ورعاية الأجيال، تسخر كافة طاقاتها المادية والبشرية لضمان الجودة على مستوى خدماتها، وعقلنة سيروراتها التربوية والبيداغوجية. كما تتعدد أبعادها التكوينية في تأطير شخصية المتعلم: على المستوى العقلي المعرفي والمهاري، والفكري الثقافي، والتربوي الاجتماعي، والروحي القيمي، والحضاري التاريخي... وتخضع أنساقها لنظام تربوي عام، وفلسفة تعليمية عليا، تتناغم مع الغايات القومية والوطنية الاستراتيجية للمجتمع، وانتظاراته الكبرى سوسيو اقتصاديافالمدرسة، كمؤسسة سوسيو-ثقافية متعددة المشارب، تتجاوز الإطارات التلقائية والظاهرية، المتمثلة في تقديم الخدمات التربوية والنفسية الكفيلة بإشباع حاجات الطفل في مختلف مراحل نموه الجسمي والعقلي والاجتماعي، إلى الدور الجسيم المجسد في حفظ الهوية الوطنية، وغرس القيم والمثل العليا، وتناقل الموروث الحضاري والتاريخي بأمانة... فالمدرسة، ذاكرة مجتمع بأكمله، وسجله الحافل بمقدسات الأمة، تعكس رصيده الثقافي : بملإ أعرافه وتقاليده، ومعتقداته، وأصالته النابعة من خصوصياته التاريخية، ومقوماته الذاتية والقومية... وهي في الوقت ذاته، المنبر الفكري والثقافي الموجه للانفتاح على الحضارات الكونية، ومدها التكنولوجي والعلمي بإيجابية ونقد عقلاني ناضج ومسؤول، دونما أي مس بالذات، أو طمس للهوية، أو نسف للثوابت، أو تسطيح للثقافة الوطنية، أوتجاوز للتاريخ.بذلك، ترقى المدرسة إلى مكانة الرافعة الاستراتيجية لتحقيق رهانات المشروع المجتمعي التنموي المندمج، والرافد الأساسي المؤهل لضمان تماسك البنى الثقافية والفكرية للمجتمع. ذلك أنها تسعى إلى إكساب النشء مختلف الأنماط السلوكية الإيجابية والقيم الاجتماعية المتوخاة، إن على مستوى التمثل أو على مستوى الفعل معا. بجانب كونها تكسب المتعلمين كفايات تغتني وتتنامى على مدى تعاقب وتسلسل مراحل التكوين، تؤهلهم للانخراط في الحياة العملية عند التخرج.فالحياة المدرسية مجتمع مصغر، يتيح للطفل فرصة الانتقال –لأول وهلة- من المحيط الأسري الصغير إلى نسيج علائقي أوسع، تتباين فيه الشخصيات الراشدة الساهرة على تدبير شؤونه. ويجد نفسه يتموقع في علاقات جديدة ومباشرة مع جماعة الأنداد، مما ينسج في حياته تفاعلات نفسية وإنسانية أخرى، ويحدد لديه أنماط سلوكات اجتماعية أوسع، تخضع لقوانين ونظام لقوانين ونظام دقيقين.كما يعمق لديه الوسط المدرسي الإحساس بل والممارسة الفعلية، لمنظومة الحقوق والواجبات في حدود التعايش والتقبل المتاحين.ولتنجح المؤسسة التعليمية في كسب هذه الرهانات الكبرى، فهي مدعوة -بحكم الضرورة لا بالاختيار- إلى احترام طابع التمايز والتفرد بين المتعلمين المتمدرسين: على مستوى الطاقات، والاستعدادات، والميولات، والإبداعات، ووتيرة المواكبة... كما أن مدعوة أيضا إلى خلق فرص التكافؤ والمساواة بين المتمدرسين في كل الأوساط الحضرية والقروية، وتوفير البنية التحتية المناسبة، والتجهيزات المادية، والشروط الموضوعية اللازمة لوجيستيكيا، لتلعب أدوارها المرشحة على الوجه المطلوب.بناء عليه، فالمدرسة والأسرة كينونة اجتماعية ثنائية ملزمة بضرورة إ يجاد صيغ تعاقدية ملائمة لتأطير العلاقات بينهما، ومد جسور التواصل الناجع والمثمر بين الطرفين.ومن ثم، تتجلى الغايات والمرامي البعيدة لشعار الموسم الدراسي الحالي الذي رفعته الوزارة الوصية: "الأسرة والمدرسة معا: من أجل بناء الجودة"، كمدخل يصبو إلى إنضاج الوعي بالتكامل العضوي بين هاتين المؤسستين القطبين في المجتمع، وكمقاربة تهدف إلى تطوير البعد الاجتماعي بكل تجلياته في صميم الحياة المدرسية للمدرسة المغربية الجديدة. بذلك عمت الدعوة كافة المؤسسات التعليمية لنهج مدخل الأبواب المفتوحة، كإضافة نوعية أخرى تسجل في رصيد ذاكرة الإصلاحات العميقة التي يشهدها الشأن التربوي حاليا، وفق مقاربة تشاركية واسعة المعنى ومتعددة القنوات.التربوي والاجتماعي الذي تنتجه التربية في أحضان الأسرة، والمدعوة إلى دعم جهود المدرسة باستمرار، والانخراط في الحياة المدرسية عن قرب: على مستوى تدبير شؤونها، وتطوير خدماتها، والارتقاء بجودة أداءاتها... وبدعم تام من طرف مؤسسات المجتمع المدني النشيطة في المحيط.ولا مناص من الإشارة هنا، إلى كون التربية وظيفة معقدة تنهل من روافد أخرى متعددة، ومن تأثيرات متنوعة مكملة خارج إطارات الأسرة والمدرسة. فالقنوات الممررة للخطابات التربوية متشعبة، تغزو بل وتحاصر الحياة اليومية لأبناء مجتمعاتنا : من إعلام، ووسائط مرئية ومسموعة ومكتوبة، ونوادي، وجمعيات، ومراكز حديثة للاتصال، ومراكز لتعلم اللغات الأجنبية، وسياحة، وأماكن للوعظ والإرشاد..ويبقى دور الأسرة والمدرسة رائدا في توجيه هذا الرصيد بتكريس الصالح فيه، وبضبط مسارات هذه الغزارة في منحاها السلبي المتحمل. بل وتصبح مع هذا الأمر الدعوة أكثر إلحاحا إلى نهج روح التكامل بينهما من أجل: تحصين توابتنا، وتكريس حضارتنا ضد أي انزلاق أو انحراف متربص في بعض الثقافات الأجنبية والأفكار الدخيلة، بفهمها الفهم الخاطئ، أو الاقتداء بشوائبها الغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا الراسخة..إن الإصلاح يرنو إلى تأسيس مدرسة وطنية جذابة ومحفزة، تنخرط في مواقع جديدة :مدرسة تفكر بهموم المجتمع، وترسخ مكتسباته الثقافية، وتستلهم غاياتها من مشروعه الحداثي الديمقراطي المأمول... فهي دينامية جديدة، ودفعة نوعية بديلة لتطوير نظمنا التربوية، تتوخى تجاوز نمط المدرسة المستهلكة للمعرفة بشكل موجه ومنظم والذي توجه إليه مسؤولية إنتاج أجيال من المتعلمين الخاضعين للهيمنة الفكرية، إلى نهج تربوي أكثر منهجية، ومداخل بيداغوجية أكثر مرونة وتمحورا حول شخص التلميذ كقطب للاهتمام على مستوى الفعل والمبادرة، مع تركيزها على الإشكالات التنموية الاجتماعية في الموضوعات المعرفية الجوهرية المعدة لتحديد المادة الدراسية المطروحة للبحث... في ظل نمط مدرسة متفتحة، تستحضر النظرة الشمولية في بناء أنساقها التربوية انطلاقا من فكر نقدي مسؤول، بإعدادها لمتعلم قادر على فهم واقعه وتخطي تحدياته، والاندماج بإيجابية في صلب التحولات الاجتماعية الهادئة، والتواصل بمنظور حضاري أصيل مع مد الثقافة الكونية... تلك إذن هي مدرسة المبادرة الذاتية للتلميذ المتوخاة في منظومة الإصلاح، والحقل الحقيقي للتجارب، والفضاء الأمثل للبحث والإبداع والخلق، والمنبر المحفز لمساءلة الذات المنتجة لديه عن طريق بيداغوجية التعلم، ومؤسسة التأهيل الاجتماعي الداعية إلى بناء العلاقات الاجتماعية بكل مقاييس الدمقرطة والتعايش.إلا أنها مسؤولية معكوسة، فالأسرة مدعوة بدورها لتأطير هذه الاختيارات عن طريق المقاربة التشاركية، والتخلي عن موقفها التقليدي تجاه المدرسة المتصف بالحياد، أو مجرد الملاحظة الخارجية المتحفظة، والاستقبال الآلي لنتائج التقويم الجزائي..بل إنها مدعوة إلى إعادة النظر في أساليب التربية الأسرية ذاتها، لتتناغم مع هذه الآفاق والتصورات، استجابة لروح العصر وطروحات التغيير فيه.وتعتبر جمعيات أمهات وأولاء التلاميذ، الشريك الحيوي في صلب القرارات الاستراتيجية للمدرسة: كتدبير الإيقاعات، وتمويل البنية التحتية والنهوض بمختلف المشاريع، واستشراف المستقبل، وتقويم الأداءات، ومقاومة الصعوبات، والحد من المعيقات الهدامة (كالهدر، والفشل، والعنف المدرسي...). كما أن استدماج النهج التشاركي، يحيلنا على تعدد الآليات والسبل وقنوات انخراط الأسرة في الشأن التدبيري للمدرسة، وتعدد أشكال وأساليب حضورها الفاعل : من برامج دراسية جهوية وإقليمية، ومشاريع تربوية، وتدبير للفضاءات التربوية، ومجالس التدبير، ومنتديات الإصلاح... وتمثيلية فعالة في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.بذلك يكون العبور الحقيقي إلى التغيير، تكامل مع الآخر خارج النظرة المؤسساتية الضيقة للذات، ولا ينضج إلا بتواجد كل من المؤسستين الفاعل بقوة، الواحدة منهما في قلب الأخرى.ويبقى دور هيئات المجتمع المدني عامة والإعلام خاصة، أنجع القنوات للتركيب بين هذه الأبعاد على مستوى التفكير والفعل والمبادرة إخصابا لروح الاندماج، وتحسيسا بجذوى وحيوية هذا النوع الوازن من التعاقدات الاجتماعية الرفيعةكما أن غايات وتوجهات التغيير المنشود، تتجاوز الآفاق المختزلة للشعارات المناسباتية العابرة، المرتبطة براهنية الأحداث والمواسم المعزولة، إلى المفهوم الواسع للدعامة المركزية في حمولة الإصلاح التربوية، بترجمتها لمشهد آخر قوي، ناطق بفعالية التلاحم والتوافق الاجتماعي من أجل مجتمع حداثي منسجم ومتماسك. | |
|


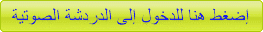
 أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم إلى منتدياتے أناروز
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم إلى منتدياتے أناروز



